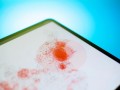الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
بالعودة إلى اتّفاقيّة أوسلو (2)

حازم صاغية
بقلم - حازم صاغية
صار من المعارف الشائعة أنّ بنيامين نتنياهو لم يتلكّأ في تعبئة اليمين المتطرّف، القوميّ منه والدينيّ، في حملته على أوسلو، وعلى اسحق رابين الذي رسمه ملصق شهير ضابطاً نازيّاً، وانتهى الأمر باغتياله في 1995.
قبل ذاك بعام أقدم المسعور الدينيّ باروخ غولدشتاين، الأميركيّ الإسرائيليّ وأحد أتباع مائير كاهانا ومحازبيه، على قتل 29 فلسطينيّاً يصلّون في الخليل.
لقد اعتُبر اغتيال رابين التحوّل الأساسيّ الذي طرأ على عمليّة أوسلو، وكان مقدّمة الانهيار البطيء الذي راح يعانيه «معسكر السلام». وعلى الجبهة الأخرى، كان للعمليّات «الاستشهاديّة» المتصاعدة التي تشنّها «حماس»، بالغةً ذروتها منتصف التسعينات، أن وضعت الأجندة الأمنيّة حيث كانت تحلّ الرغبة السلميّة. وتلازم الانفجار هذا مع تصعيد التوتّر على الجبهة اللبنانيّة الإسرائيليّة، في 1993 وخصوصاً 1996. وبدوره مهّد هذا الجوّ الاستقطابيّ والأمنيّ الطريق لانتصار انتخابيّ أحرزه نتنياهو بفارق ضئيل، ولهزيمة مهندس أوسلو ورجلها الثاني شمعون بيريز.
ومع تنامي العنف الإرهابيّ الذي مارسته راديكاليّات الجانبين، من دون أن تخفى الرعاية السوريّة والإيرانيّة لأفعال «حماس» وأخواتها، وُلدت شتيمة «الأوسلويّة» من رحم شتيمة «العرفاتيّة» التي ابتكرتها دمشق الأسد.
ومع أنّ السلام أحرز انتصاراً ثانياً أواخر 1994، بتوقيع معاهدة وادي عربة الأردنيّة الإسرائيليّة، لم تُبد القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها عرفات، المسؤوليّة التي يتطلّبها سلام صعب ومعقّد والتزامٌ باتّفاقات دوليّة ليست من طباع الزعيم الفلسطينيّ. ذاك أنّ تجربة الأخير اقتصرت على مناورات وصغائر كان يتبادلها مع المجتمعات الأهليّة والأنظمة الأمنيّة في المشرق.
وكانت رقعة الاعتدال الفلسطينيّ تنكمش وتتقلّص، ما أظهره تمزّق عرفات وانشطاره بين التزام بأوسلو وعدم التزام، وذلك تبعاً للمزايدة التي فرضها عليه الراديكاليّون الفلسطينيّون والعرب والإيرانيّون ممّا تعاظم لاحقاً مع «الانتفاضة الثانية». وفي 1994، ومن أحد مساجد جنوب أفريقيا، كانت سقطته بتشبيهه أوسلو بـ«صلح الحديبيّة» بين النبيّ محمّد وقريش، وهذا فيما الإسرائيليّون يأخذون عليه عدم مواجهته العمليّات الإرهابيّة المتزايدة واكتفاءه بإدانتها.
كذلك لم تحلّ حكومة منتخبة في الضفّة والقطاع، كما كان يُفترض، محلّ السلطة الوطنيّة، وتمكّن الفساد والمحسوبيّة والحكم الاعتباطيّ من ممارسات تلك السلطة. وبعدما كانت استقصاءات الرأي تشير إلى تأييد أكثر من ثلثي الجمهور الفلسطينيّ لأوسلو، جعل هذا الدعم يتآكل وتتزايد القناعة بأنّ السلام عديم الإنجاز والنفع. فالسلطة التي انبثقت من السلام غير مُقنعة، والاحتلال لا يزال قائماً، والحواجز المحيطة برام الله تتكاثر، بتكاثر الإرهاب، عدداً وعدوانيّةً وخنقاً لحركة الفلسطينيّين. وبعدما كان المستوطنون اليهود، مع توقيع أوسلو، 110 آلاف في الضفّة والقدس الشرقيّة، جعل العدد يتزايد بعشرات الآلاف ثمّ بمئاتها، دونما اكتراث بتحريم القانون الدوليّ للاستيطان. وأبعد من العدد أنّ ذاك الاستيطان الذي بدأ وظيفيّاً، يحدوه البحث عن شروط سكن وحياة أرخص تكلفةً ممّا في المدن، راحت تتعاظم حوافزه الآيديولوجيّة، الدينيّة والقوميّة، المتشبّثة بالاستحواذ على الأرض.
وتكاملت هشاشة السلطة الفلسطينيّة حيال شعبها وضعف موقعها حيال الإسرائيليّين، فبات كلّ من العاملين يغذّي الآخر. فلأنّها أعجز من أن تردع الأعمال الإرهابيّة باتت أعجز من أن تفرض على الإسرائيليّين وقف الاستيطان، أو أن تكون أشدّ تحكّماً في ممارسة «التنسيق الأمنيّ» معهم، والعكس بالعكس. وهذا ما أظهرها، هي المسكونة بالبرهنة على عدم خرقها الاتّفاقات، أقربَ إلى أداة في يد إسرائيل، مهمومة فحسب بالحفاظ على فتات سلطة فاسدة، كما أظهرها، في المقابل، جزءاً من النشاط الإرهابيّ ضدّ الإسرائيليّين.
مع هذا لم يفقد السلام الجريح كامل قوّته ولا فقدت أوسلو كلّ حيلة. فبعد مقتل رابين مباشرة استمرّ بيريز، كرئيس للحكومة، في محاولته تطبيق الاتّفاقيّة. وحتّى نتنياهو نفسه إثر فوزه في 1996، بدا مضطرّاً للتظاهر بالتقيّد بها. ففي مطالع 1997، أعاد مدينة الخليل إلى السلطة الفلسطينيّة، ما عرّضه لانتقادات حادّة من يمينه. وفي أواخر 1998 انعقدت قمّة واي ريفير في الولايات المتّحدة، فضمّته إلى عرفات وكلينتون، حيث اتُّفق على استئناف العمل بأوسلو، وعلى الانسحاب الإسرائيليّ من بعض مناطق الضفّة، واتّخاذ تدابير أمنيّة لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، مع استئناف مفاوضات الوضع النهائيّ. وبدورها وافقت الكنيست على مذكّرة الاتّفاق بأكثريّة كبرى، كما أيّدتها أغلبيّة الإسرائيليّين. فحين حاول نتنياهو التلاعب والمناورة لتعطيل العمل بها سقطت حكومته وأجريت، في 1999، الانتخابات التي فاز فيها العمّاليّ و«الأوسلويّ» إيهود باراك.
وبفوز الأخير استعاد معسكر السلام بعض الأمل مجدّداً، ولو ظلّ أملاً ضئيلاً بقياس ما أحدثه فوز رابين في 1992. فباراك، وفي ظلّ التراجع النسبيّ في شعبيّة السلام، بدا أكثر تردّداً وأقلّ حسماً من رابين وبيريز. وفي المقابل، تراجع الرهان الفلسطينيّ على سلام كان يُحبطه تنامي القيود والحواجز الإسرائيليّة.
أمّا تأويل هذا كلّه، وسواه، بأنّ إسرائيل لم تُرد السلام ولن تريده فاختزال يشوبُه تبسيط كثير.
GMT 18:41 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
ماذا عن سوريا؟GMT 18:40 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
“أبو عمر”… سوسيولوجيا بُنية التّبعيّةGMT 18:24 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
مفكرة السنة الفارطة... عام الختام البعثيGMT 18:22 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
إسرائيل... الاعتراف الملغومGMT 17:28 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
إيران... السوق غاضبةGMT 17:26 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
مرّة أخرى... افتراءات على الأردنGMT 17:23 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
الأحزاب وديوان المحاسبة.. مخالفات بالجملة!GMT 17:19 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
إيران... المرشد والرئيس والشارعتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تسجل ارتفاعاً جديداً
الرباط - المغرب اليوم
ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 111.53 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 109.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقاً لبيانات مكتب الصرف في المغرب. وأوضح مكتب الصرف، في نشرته حول المؤشرات الش�...المزيدويل سميث يواجه دعوى قضائية بعد اتهامات عازف كمان بالتحرش والاستبعاد
واشنطن - المغرب اليوم
رفع عازف الكمان المعروف براين كينغ جوزيف، دعوى قضائية، ضد النجم الشهير ويل سميث البالغ من العمر 57 عاماً، وشركة "تريبول ستوديوز مانجمنت" بتهم التحرش الجنسي والفصل التعسفي والانتقام. وقدّم نجم "أميركا غوت تا�...المزيدماسك يعلن أن «نيورالينك» تخطط لإنتاج كميات كبيرة من شرائح الدماغ في 2026
واشنطن - المغرب اليوم
قال إيلون ماسك في منشور على منصة «إكس» إن شركته نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ ستبدأ «إنتاج كميات كبيرة» من أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب وستنتقل إلى إجراءات جراحية آلية بالكامل في عام 2026. ولم ترد نيو�...المزيدنزاع بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الدواء المصرية حول كتاب توثيقي عن تاريخ صناعة الدواء
القاهرة - المغرب اليوم
بسبب ما وصفته مكتبة الإسكندرية بالتصرف الأحادي من قبل هيئة الدواء المصرية، ومخالفة عقد إصدار كتاب توثيقي مشترك يرصد تاريخ وحاضر صناعة العلاجات في مصر بعنوان «الدواء في مصر... رحلة عبر الزمن»، نشبت بوادر نزاع ب...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©